كمال شاهين
تفسير اللوحة الفنية: خطوات نحو التذوق الفني الصحيح
قراءة اللوحة الفنية سواء من جهة المتلقي أو من جهة الناقد أو المهتمين جدلية قديمة، وتكاد لا تجد اثنين يتفقان على تشريح واحد للوحة، ولعل هذا من جماليات الفن التي تجعل له حضوره اللامتناهي في الذاكرة البشرية.
هذه الفكرة سبق لكبار الفنانين حول العالم الاعتراف بها، ووجدت حضورها أيضاً في عالم التلقي الفني لدى المهتمين من شرائح مختلفة لمتذوقي الأعمال الفنية، وخاصة الأوساط الثقافية التي تتحدث كثيراً في الفن وشؤونه مدخلة إياه في جدل الفلسفي والمعرفي، متناسية ـ ربما ـ النقطة الأهم لأي عمل فني، وهي الجمالية التي يقدمها هذا العمل، ولعل الجدل القديم بين أصحاب “الفن للفن” وأصحاب “دور الفن الطليعي والاجتماعي” سيبقى مستمراً ما دام هناك إبداع وبأشكال مختلفة.
سنتحدث هنا عن جزئية من جزئيات الإبداع الفني التشكيلي، وهي قراءة اللوحة الفنية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وضع نقاط علام في طرائقه، وعدم تركه دون مؤطرات يمكن أن تساهم في رفع الذائقة الفنية دون حصر نهائي بهذه الطرق واعتبارها وحيدة في القراءة، الكل يعرف مثلاً لا حصراً كيف أن لوحات “لؤي كيالي” لقيت حتى اليوم مئات التفسيرات الفنية والنفسية والفكرية وحتى الطبية، ولذلك فنحن بحاجة ماسة للدخول في علم “الفن” وفلسفته للوصول إلى مقاربة ممكنة وليست نهائية ولا وحيدة كما أسلفنا.
أولاً: التجربة الجمالية وحدودها:
لعل الإنسان في كينونته، هو الكائن الوحيد على الأرض الذي يستطيع إصدار حكم قيمة على شيء ما أنه جميل أو قبيح، وهذا يعني بداهة الانتقال إلى الفلسفة بتجليات أسئلتها الأولى الأرسطية، أو إلى جدل أسئلة الجمال لدى “نيتشه” و”ابن عربي” و”ابن الفارض” وغيرهم، وسؤالها الأهم: كيف نتعامل مع الجمال؟ كيف نصل إليه ويصل إلينا كمتلقين وكصناع للجمال في نفس الوقت؟
إن الانفعالات التي ترافق مشاهدة اللوحة، وتلك التي تصدر بعفوية عن عمل ما بأنه جميل، أو قبيح لهي أولى الأسئلة التي تفرض نفسها على المتلقي، فبعضهم يعتبر البشاعة فناً في بعض الأحيان، والبعض الآخر يعتبره محرضا أكثر للانفعالات؟ ولكن هل يسمى القبح فناً ومثاله الأوضح تلك النزعات الفنية التي جاءت تحت اسم “ما بعد الحداثة”؟
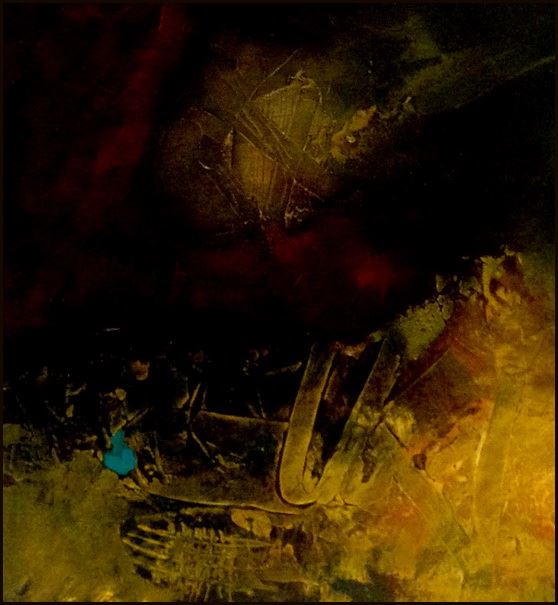
لوحة تجريدية للفنان “أحمد أبوزينة”
إن الانفعالات النفسية غير “محصنة” من الهوى الذاتي بحد ذاتها، وهي تنبع من منابع متخالفة ذاتياً ومجتمعياً. ويحتج معارضو هذه الفكرة على أن قيمة الفن لا تتحدد بهذه الاستجابات بل إن قيمته تكمن فيه بحد ذاته.
يقدم الناقد والفنان الأميركي “جيروم ستولينزوم” في كتابه “النقد الفني”[1]اقتراحات لحل هذه المعضلة، فيبدأ في التدقيق على الاعتقادات التي تشكل جزءاً من منظومة الوعي اليومي للفرد، وهي في الغالب منبثقة من عبارات شائعة غير مدقق على صحتها أو سلامتها العقلية، ولو أن بعضها صحيح ومثبت التجربة، ومن الانفعالات التي تتخذ مظهر أفكار وهي ليست كذلك، على أن هذا ليس بالأمر المستغرب فكثير من مواقفنا اليومية تتخذ هذا اللبوس دون وعي، وكثيراً ما نسحب كلامنا عن عمل فني عندما يحضر الرأي الناقد الحصيف الذي يجلي لنا الصورة الفنية للعمل بشكل نشعر معه بأنه كان يجب أن نتريث في إصدار “الحكم”.
إن أغلب النقاد يوضحون معايير القيم النقدية التي يستخدمونها في قراءة العمل الفني، وتظهر هذه المعايير دون انتباه وأحياناًً مضمنة في الكلام، فاستخدام مصطلح مثل “الجمهور” و”الصراع الطبقي” يحيل فوراً إلى المدرسة الماركسية في النقد، واستخدام “التعالي” و”التصعيد” و”الاستبطان” يحيل إلى المدرسة النفسية، وكما أن هناك نقد يصلح لمرحلة فنية فهو لا يصلح لمراحل ثانية أو تالية، ومصطلحات “الرومانسية” لا تنطبق على “التعبيرية” وكذلك لا تنطبق على “السوريالية” وهكذا.
إضافة إلى هذا فإن هناك معاييراً إضافية لا تقل أهمية عما سبق، وهي المكان أو ما يسميه البعض “فضاء اللوحة”، فكما يقول الناقد “دوجلاس مورجان” في مقال له نشر في مجلة “النقد الفني” الأميركية: «إن الاستجابة للوحة مثل “الجرينكا” (لوحة بيكاسو الشهيرة عن الحرب الأهلية الإسبانية) على حائط متحف ليست مماثلة على الإطلاق للمقارنة بين مستطيلات من الورق المقوى، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن الجمع بين عدد من مقارنات الورق المقوى هذه الواحد منها فوق الآخر»[2].
هذه الشروط الأولية لا تعني بالمطلق نخبوية معينة يجب أن تكون للمتلقي حتى يبدأ مشواره للوحة، بل إن وعي هذه الشروط يمثل الطريق الصحيح لتحقيق الحد الأدنى في القراءة الفنية مهما كانت المدرسة الفنية النقدية أو حتى المعرفة البسيطة للمتلقي، وانطلاقاً منها يمكن تحديد آليات التذوق الفني لكل لوحة على حدة.

لوحة تجريدية للفنان “ياسر حمود”
ثانياً: الشيء والعين واللوحة:
إن القارئ الأول للوحة هو العين، فالألوان والأشكال تستوقف العين بدرجات متفاوتة، وكل مشهد بصري أو جزئية حتى تنتقل إلى الدماغ ليعمل الأخير على تفسيرها وفقاً لعناصر كثيرة، فقد يكون المثلث في اللوحة لدى البعض “هرماً مقدساً” وقد يكون لدى آخر “وجهاً”، على أن هذا الاختلاف في التفسير وهو طبيعي جداً، هو ما يمثل قيمة الفن من جهة، وما يعطي للفن خلوده وبقاءه منذ بدء الحضارة الإنسانية، فالاختلاف محرك الوجود.
وأول خطوة في طريق التذوق الفني هي استرجاع العين لسذاجتها البصرية وسرعة تجاوبها مع الاندماج لحظة المشاهدة مع اللوحة، ويعني هذا الأمر التوقف لحظياً عند ثلاث عناصر في اللوحة، هي الخط والكتلة واللون كنقط رئيسية للبدء، ثم الانتقال للتعرف على المشهد البصري للوحة وجوانبه المختلفة من موضوع فني وطريقة رسم ومنهج تلوين وطريقة تقديم الموضوع وهكذا.
التأثير النوعي، والجاذبية التي تؤثر بها مختلف التكوينات اللونية والكتلوية ترجع إلى طبيعتها الذاتية، وإلى الشكل الذي تبدو فيه للعين، ولا يكفي للإعراب عن هذا التأثير اللجوء إلى اللغة والكلام، فهناك تجربة ترتقي عن اللغة لتصل حد القول بالذوبان كما عند الصوفيين في تجربتهم مع الوجود، يعبر “دي ويت باركر” عن هذه التجربة بقوله: «لا يكفي أن تحركنا الصورة عن طريق الوجود التعويضي لشيء مثير مرسوم على اللوحة، بل يجب أن تهزنا مباشرة عن طريق مخاطبة الحس مباشرة»[3]
يساهم اللون في تقديم هذه المخاطبة حتى مستوياتها العليا، فاللون في الذاكرة البشرية تحول إلى رمزية هائلة الحضور في السياق اليومي، كما أن اختلاف درجات اللون نفسه يعطي مدلولات مختلفة، كذلك فإن هناك حقيقة أصبحت ثابتة هي أن هناك تنافر في الألوان، وثمة ألوان ساطعة وحادة، مثل البنفسجي والأرجواني، وهناك ألوان هادئة رقيقة مثل مشتقات الأزرق، وهناك ألوان صادمة على اللوحة لا يتوقع وجودها دائماً مثل الذهبي، ومن المهم معرفة أن قدرة الأشخاص على استقبال الألوان تختلف بين فرد وآخر، فبعضهم لديه قدره على التقاط الفروقات الطفيفة في أي لون، وربما بالتالي يتوقف جو اللوحة على قدرة الفنان على استغلال هذه الإثارة العصبية الأولى التي تحدثها هذه الفروق اللونية[4].
من اللون إلى الخطوط، تكون النقلة التالية في القراءة، من الضروري التنبيه إلى أن هذا التفصيل ليس إجبارياً، ولكنه طريقة في القراءة يمكن تقديم عنصر فيها على آخر، الخطوط في اللوحة لها تأثيراتها الفرعية مثل الألوان، وتوازن الخطوط في أي عمل فني مقدمة أساسية لتلقيها المريح وجودتها الفنية، فللخطوط المستقيم منها والمنكسر والمضلع والأهليليجي والمدبب والمصقول والمتماوج وما إلى ذلك “نغمات” مختلفة وارتباطات عصبية تقدم إحساساً بديلاً عن اللمس وكذلك عن العاطفة، ونحن نكاد نتحرك مع الخطوط على اللوحة في غالب الأحيان قبل أي شيء آخر.
تشكل الخطوط إيقاعاً “ما” في اللوحة، وعندما نصل إلى إحساس أنه مكسور (بما يشبه الموسيقا) سوف نشعر بفقدان الإدراك الحسي، وسوف تنكسر استجابتنا الدفعية الحركية في المتابعة، الخط السلس المتماوج يفك التوتر وييسر إدراكنا ويجلب السرور والبهجة، ويظهر بالتالي الإحساس “المتسرب إلينا من اللوحة”.[5]
ثالثاً: المراقب الحيادي والمتلقي:
كما أشرنا فإن الانفعالات التي تثيرها اللوحة تتساوق مع نقطة مهمة تحتل مساحة لا بأس بها في اللاوعي، وهي اسم الفنان، فكثير من المتلقين حتى المتقنين لفنون قراءة اللوحات يقفون بحذر وإعجاب أمام الأسماء الكبيرة فنياً تلك التي صنعها وصدرها الأعلام، وقد تكون لا تمتلك أعمالهم تلك القيمة العليا لا في الشكل ولا في المضمون الفني ولا حتى في التقنية، من هنا فإن محاولة الحيادية في قراءة اللوحة تشوبها ثغرات كثيرات، بعضها ذاتي والآخر موضوعي، وبينهما يجب دوماً التوقف ملياً أمام أي عمل لاستكشاف مضامينه ورسائله.
لوحة تجريدية للفنان “حمود شنتوت”
نخلص فيما سبق إلى الحاجة دوماً إلى تفكيك الرسائل البصرية التي ترسلها ريشة الفنان ورؤيته إلى العالم عبر مجموعة إجراءات تساهم في خلق الذائقة الفنية وعدم الوقوع في فخ الاستسهال لأي موضوع فني مقدم.
المراجع:
[1] ترجمة فؤاد زكريا ـ القاهرة ـ 2010



