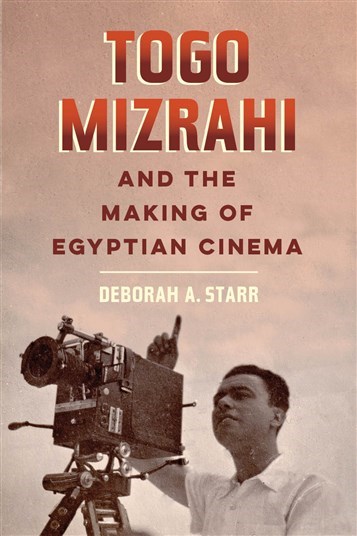
ديبورا ستار
(جامعة كاليفورنيا للنشر، 2020)
جدلية (ج): ما الذي دفعك إلى كتابة هذا الكتاب؟
ديبورا ستار (د.س.): وجدت أنّ قصّة توغو مزراحي ملحّة جدًّا. كان مزراحي يهوديًّا مصريًّا، جنسيته إيطاليّة. وهو أحد روّاد صناعة الأفلام المصريّة، أسسّ استوديو تصوير وشركة إنتاج في الإسكندريّة في عام 1929. وأصبح مزراحي واحدًا من أكثر مخرجي الأفلام الكوميديّة والموسيقيّة غزارة، عاملًا مع العديد من الممثلين الذين يتمتّعون بالشعبيّة، من بينهم أمّ كلثوم، ويوسف وهبي، وعلي الكسّار. وقد قدّم عبر الشاشة الممثل الكوميدي اليهودي شالوم (ليون أنجل). وأخرج مزراحي أيضًا خمسة أفلام من بطولة المغنيّة المصريّة اليهوديّة ليلى مراد، منها “ليلة ممطرة” (1939) و”ليلى” (1942). في المحصّلة، أخرج توغو مزراحي، بين العامين 1930 و1946، ثلاثين فيلمًا طويلًا بالعربيّة، وأربعة باللّغة اليونانيّة.
وفي حين كانت سيرة مزراحي المهنيّة كصانع أفلام استثنائيّة، كان منحى حياته الشخصيّة مماثلًا لتجارب اليهود المصريين الآخرين. في منتصف القرن العشرين، ولمّا تغيّرت الرياح السياسيّة، غادر توغو مزراحي مصر. وفي الستينيات، صودرت شركة الإنتاج الّتي أسّسها، وحُجر على ممتلكاته. وعلى امتداد العقود اللاحقة، ورغم استمرار شعبيّة أفلامه، إلا أنّ إرثه بهت، كما ذكرى التاريخ اليهودي وثقافته في مصر. عبر كتابة هذا الكتاب، أنطلق لاستعادة حياة وأعمال صانع الأفلام المهم هذا.
(ج): ما هي الموضوعات والمسائل والأدبيات التي يتناولها الكتاب؟
(د. س.): في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، عمل في صناعة السينما المصريّة مصريون من الأديان كافّة، بالإضافة إلى مقيمين من غير المواطنين – بمن فيهم أبناء أقلّيات يحملون جنسيّات أجنبيّة، ورعايا عثمانيون سابقون من المشرق، وأوروبيون -. ولقد كُتب الكثير عن كيفيّة تعريف ما هو “مصري” في الأفلام المنتجة محليًّا في تلك الفترة. وأنا أرفض قطعيًّا المقاربة السائدة – مع أنها إشكاليّة تاريخيًّا ونظريًّا – التي ترسم حدود السينما المصريّة بحسب جنسيات المشاركين فيها.
بدايةً، ومن منظور تاريخي، تساهم عوامل متنوّعة في العمليّة المعقّدة والمضطربة لبناء الجنسية في مصر، لا سيما بالنسبة لليهود المصريين. في الكتاب، أقترح نماذج بديلة عن تعريف السينما المصريّة على أنّها سينما وطنيّة بلا جنسيّة. وأحلّل المؤسّسات التي صاغت تطوّر صناعة الأفلام المصريّة، بالإضافة إلى توافق محترفي السينما مع المشاريع القوميّة المصريّة.
وكان مزراحي، مثل العديد من صناع الأفلام المصريين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، يعتبر أنّه ملتزم بمشروع له أهميّة وطنيّة. وكان صناع الأفلام، والنقّاد، والمشاهدون على حد سواء يعتبرون السينما المنتجة محليًّا مصدرًا للفخر الوطني. وكان المشاهدون المصريون يريدون ترفيهًا يُنتَج محليًّا. أمّا العاملون في صناعة الأفلام فقد روّجوا للسينما المحليّة على أنّها وسيلة لمحاربة السيطرة الثقافية الأجنبيّة. وتميل عمليات التأريخ للسينما المصرية إلى التركيز على تأسيس “استوديو مصر” سنة 1934، إلا أنّها تغفل مساهمات الاستديوهات المستقلّة في تلك الفترة ومشاركتها في البرنامج الوطني ذاته. أرى هذا الكتاب بمثابة تصحيح لذلك الإغفال.
وقد أشاد النقّاد المعاصرون بمزراحي لجودة أفلامه كما لإسهاماته في بناء صناعة السينما المصريّة. في الثلاثينيات من القرن الماضي، شارك مزراحي في مساعي إنشاء نقابات سينمائيّة للتحرّك من أجل حماية صناعة الأفلام المصريّة الوليدة. في وقت لاحق من مسيرته المهنيّة، لجأ مزراحي إلى الصحافة لزيادة وعي الجمهور حول المسائل التي تعيق تطور صناعة السينما المصريّة. وكان مزراحي فنانًا ورجل أعمال في آن. وفي إحدى مقالاته، وحين قدّم توصيات لدور السينما، لم يحثّها على عرض المزيد من الأفلام المصريّة فحسب، بل أيضًا على دعم تشكيلة أوسع من الأنواع السينمائية المنتجة محليًّا. وكان مزراحي يعتبر أنّه يساهم في بناء نوع فنيّ محليّ، وصناعة محليّة حيويّة في آن.
في الكتاب، أفحص عن قرب عددًا من أفلام مزراحي، منذ بداياته مع شالوم وعبده في الفيلم الكوميدي “المندوبان” (1934) وحتى تحفته الأخيرة “سلامة” (1945) من بطولة أمّ كلثوم. وأستخرج الانعكاسات الثقافيّة والسياسيّة في أفلام مزراحي، معيرة انتباهًا خاصًّا إلى بناء الوطنيّة التعدّدية، وكيفيّة إظهار اليهوديّة، والاستخدام المربك لفئات جندريّة غير مستقرّة. وفي أفلامه الكوميديّة والموسيقيّة، يستخدم مزراحي أعماله كمنبر لمعالجة القضايا الاجتماعية، من التفاوت في الأجور إلى التغيّر في أدوار النساء في المجتمع المصري. ومن خلال تحليلي للأفلام، أحاول أن أفسح المجال أمام مزراحي للتحدث من خلال فنّه.
(ج): كيف يرتبط هذا الكتاب أو يبتعد عن أعمالك السابقة؟
(د.س.): في بحثي السابق، درست أدب نهاية القرن العشرين وأفلامه التي تلجأ إلى الحنين في إظهار العلاقات المترابطة بين الثقافات في مصر قبل الخمسينيات: بين المسلمين، والمسيحيين، واليهود، بين المصريين، والمهاجرين من الأراضي العثمانيّة السابقة، والإيطاليين واليونانيين. كنت أريد أن أفهم المناخ الثقافي الذي أوحى بهذا النوع من الحنين القوي بين كتّاب نهاية القرن العشرين. وعلى عكس الأدب، فإنّ السينما هي، بنيويًّا، عمل مشترك، وكما قلت سابقًا، الصناعة ذاتها كانت متنوّعة جدًّا. فبدأت أستكشف كيف ظهرت سرديات العيش المشترك في السينما المصريّة.
يعكس هذا المشروع أيضًا تحوّلًا نظريًّا في مقاربتي لدراسة التبادل الثقافي. في كتابي “تذكّر مصر الكوزموبوليتانية: الأدب، الثقافة، الإمبراطوريّة” (دار روتلدج، 2009)، بحثت في العلاقات المتداخلة بين التجربة الاستعمارية وبين مفهوم الكوزموبوليتانية. كتاب “توغو مزراحي وصناعة السينما المصريّة” يعكس تحولًا من الكوزموبوليتانية نحو مفهوم “المشرقية”. في هذا الكتاب أدرس التقاطع بين التنوّع في الأفلام المصريّة، وبين الطبيعة العابرة للحدود الوطنية في صناعة الأفلام، وبين مفهوم “المشرقية”.
(ج): ماذا تقصدين بالمشرقيّة؟
(د.س.): توصلت إلى تعبير “المشرقيّة” من خلال أعمال الكاتبة المصريّة اليهوديّة جاكلين شحيت كاهانوف. حين كانت تكتب في إسرائيل الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت المخاوف من الاختلاط الثقافي التي تبنتّها قيادة الصهاينة الأشكيناز قد أدّت إلى إطلاق تعبير “مشْرَقة” المُضلل عليها. واعتمدت جاكلين كاهانوف تعبير “المشرقيّة”، وأعادت تعريفه. وبنت على تجاربها كونها ترعرعت في مصر ما بين الحربين، واعتبرت أن “المشرقيّة” هي تكوين اجتماعي مختلط، وقوّة دمج اجتماعي.
وجدت أنّ مفهوم “المشرقيّة” هو إطار عمل يسلّط ضوءًا لدى القراءة في الأفلام المصريّة الأولى، لا سيما لدى السعي لفهم المهازل المضحكة حول الهويّة المغلوطة. واكتشفت أن لهذه الأفلام ثلاثة قواسم مشتركة، هي ما أُسّميها “أسلوب سينمائي مشرقيّ”.
أولًا، تجسّد الأفلام المشرقيّة أخلاقيات التعايش، وأحيانًا تروّج لها. ثانيّا، هي تستخدم الأدوات السينمائيّة لتشييد جماليّات التعدّدية. وأخيرًا، تعالج هذه الأفلام مسألة الهويّة على أنّها مرنة وقابلة للتغيير.
تشمل أفلام توغو مزراحي حبكات عن الهويّة المغلوطة، كما تتناول مفاهيم الجندرة والعرق والهويّة الوطنيّة الإتنيّة. وأنا أستخدم مفهوم المشرقيّة لاستكشاف إمكانيات عمليّة عدم التحديد هذه.
وتستهدف أخلاقيات التعايش المشرقيّة الجليّة في أفلام مزراحي القوميات الضيّقة التي كانت تزداد شعبيّة في مصر في ذلك الوقت.
(ج): من تأملين أن يقرأ هذا الكتاب، وما نوع التأثير الذي ترغبين أن يخلّفه؟
(د.س.): للسينما المصريّة قاعدة ضخمة من المعجبين عالميًّا. وكما أشير في الكتاب، فإن نسخةً من فيلم مزراحي “عثمان وعلي” (1938) من بطولة علي الكسّار شوهدت أكثر من مليون مرّة عبر موقع يوتيوب. وأنا أعي أيضًا أنّ هناك اهتمامًا بمصر في الدول العربيّة الأخرى، كما بين اليهود الشرقيين، لمعرفة المزيد عن تاريخ وثقافة يهود الدول العربيّة.
كتبت هذا الكتاب على أمل الوصول إلى مجموعة واسعة من القرّاء المهتّمين بالتعرّف على تاريخ السينما المصريّة والإنتاج الثقافي لليهود المصريين. وكنت سعيدة جدًّا بالعمل مع دار جامعة كاليفورنيا للنشر لقيامهم بنشر الكتاب عبر برنامجهم “لومينوس” الذي يتيح للجميع، أينما كانوا في العالم، أن يحمّلوا الكتاب عبر الإنترنت ويقرأوه مجّانًا.
في الإطار الأكاديمي، آمل الوصول إلى جمهور في ميادين الدراسات الشرق أوسطيّة، والدراسات اليهوديّة، ودراسات الأفلام. أعتبر أنّ هذا الكتاب يدخل في نقاش مع العدد المتنامي من الأبحاث حول الإنتاج الفكري والثقافي والفنّي ليهود الدول العربيّة في العصر الحديث.
وفي حين يركّز هذا الكتاب على الإنتاج الثقافي اليهودي في مصر، إلا أن الأسئلة التي يطرحها حول الهويّة، والجنسية، والانتماء الوطني، لها تداعيات على الحقل الأوسع للدراسات اليهوديّة. كما أنّني كنت في غاية السرور لنشر هذا الكتاب ضمن سلسلة جديدة ترى أن دراسات السفرديم والمزراحيين هي جزء لا يتجزأ من دراسة التاريخ اليهودي الحديث وثقافاته. إلى ذلك، فإنّ هذا الكتاب يسدّ فجوة في دراسات السينما. ومصر هي قوّة رئيسيّة في الإنتاج السينمائي، لها توزيع واسع في الدول العربيّة وما يتجاوزها. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الدراسات التي ترقى إلى حجم الكتب عن السينما المصريّة باللغة الإنجليزيّة.
(ج): ما هي المشاريع الأخرى التي تعملين على إنجازها الآن؟
(د.س.): أتوقع الاستمرار لمدّة في دراسة السينما المصريّة في ثلاثينيات القرن العشرين لمواصلة استكشاف مسائل العرق، والجندرة، والجنسيّة. وفيما كنت أعمل على المسائل العرقيّة التي أثارتها أدوار علي الكسّار في الأفلام التي أخرجها توغو مزراحي، أثارت اهتمامي الشخصيّة المصنّفة عرقيًّا التي تؤدّيها الممثّلة المصريّة كوكا، في كل من أدوارها في السينما المصرية، وفي تغطيّة الصحافة المصريّة لظهورها في الفيلم البريطاني “أريحا” (1937) إلى جانب الممثّل الأفريقي الأميركي بول روبسون. والافتراضات التي انعكست في الصحافة المصريّة توضّح مفاهيم العرق والهويّة في مصر ما بين الحربين. كما أنوي البحث أكثر في مرونة الجندرة في أفلام آسيا داغر.
مُقتطف من الكتاب
نسمع فرقة تستهلّ عزف موسيقى احتفاليّة. نرى باعة متجّولين يبيعون سلعهم من عربات تصطف في أحد شوارع المدينة. يعبر رجل وصبي، يمسك كلّ منهما بيد الآخر، من أمام الباعة. وفيما هما يتلاشيان ضمن حشد بعيد، يتجوّل شابّان، كلاهما يرتديان بزتين غربيّتين ويعتمران طربوشين، يظهران ضمن إطار الصورة تارة، وتارة خارجها. يقوم شخصان، أحدهما بجلّابيّة داكنة اللون وطربوش والآخر بجلابيّة فاتحة اللون وعمامة، بدفع أرجوحة عاليًا في الهواء، مخترقة إطار الصورة على شكل قوس.
كان مزراحي يهوديًّا مصريًّا، جنسيته إيطاليّة. وهو أحد روّاد صناعة الأفلام المصريّة، أسسّ استوديو تصوير وشركة إنتاج في الإسكندريّة في عام 1929. وأصبح مزراحي واحدًا من أكثر مخرجي الأفلام الكوميديّة والموسيقيّة غزارة، عاملًا مع العديد من الممثلين الذين يتمتّعون بالشعبيّة، من بينهم أمّ كلثوم، ويوسف وهبي، وعلي الكسّار.
يدور أطفال صغار على متن لعبة الأحصنة الدوّارة. رجال يدفعون عجلة ملاهٍ تعمل يدويًّا، فيما الإطار يُظهِر سيّارات تمر الواحدة منها تلو الأخرى مملوءة بالأطفال ثمّ تختفي. بائع يحني إبريقًا نحاسيًّا كبيرًا مزخرفًا فينساب شراب شفاف من خرطومه الطويل في استدارة واسعة لملء كأس. في حديقة، تلعب فتيات بفساتين ألوانها زاهيّة لعبة المطاردة. رجلان بمعطفين وطربوشين يمشيان في زقاق، تتبعهما مجموعة صبيّة يتوقّفون للنظر إلى آلة التصوير. في الخلفيّة، إلى اليسار، امرأة بملابس سوداء ونقاب تنظر أيضًا باتجاه آلة التصوير. خلفهم إلى اليمين، رجل بجلابيّة بيضاء وعمامة رأس، يجلس على العشب، منغمسًا في نقاش ما. عند البحر، يمشي أفراد أسرة على امتداد الشاطئ، وفي جنوبي الإطار تبدو الأكواخ الساحليّة المميّزة وكورنيش الإسكندريّة.
أشخاص يتحلّقون في مجموعات صغيرة في نزهة على الرمل. كشاكش تنانير نساء، يرتدين أحدث الأزياء الأوروبيّة، ترفرف مع نسيم البحر كما أقمشة مظلات الشاطئ.
تقنيات وحركة تصميم هذا المونتاج تظهر في فيلم مصري من العام 1937 هو “العزّ بهدلة”. ويعرّف عنوان على الشاشّة عن الاحتفال بأنّه “شمّ النسيم، عيد الشعب”. وشمّ النسيم هو مهرجان ربيعي له سمات مشتركة مع احتفالات موسميّة أخرى في المنطقة، مثل “عيد النيروز”، وشمّ النسيم هو أيضًا مهرجان مصريّ حصرًا، تعود جذوره إلى الطقوس الفرعونيّة. وخلاله، يخرج الناس إلى الشوارع، والمنتزهات، والشواطئ والمساحات الخضراء.
والمشاهد الملتقطة تظهر ما يبدو أنّهم سكّان الإسكندريّة وهم يشاركون في نشاطات ترفيهيّة في أماكن يمكن التعرّف عليها بسهولة. ولا يظهر أي من الممثلين المشاركين في الفيلم في المونتاج. ويُظهر الأطفال حشريّة إزاء آلة التصوير. فالمشاهد مدعوّ لأن يرى هذه المشاهد على أنّها حقيقيّة، حتّى لو كنّا نعرف أنّها جزء من المونتاج. وتزوّد الدلالة الاجتماعية للملابس المشاهد بأدوات لتصنيف الأشخاص الظاهرين في المونتاج.
ويتم إظهار أفراد الطبقة الوسطى الناشئة، الأفنديّة، وهم يسعون للترفيه والتسليّة إلى جانب أبناء الطبقات الشعبيّة. والمونتاج المصمّم بإتقان يبني يومًا احتفاليًّا يقوم خلاله أبناء الإسكندرية من الفئات الاقتصادية الاجتماعيّة كافّة بالاحتفال في الأماكن العامّة معًا.
وفي حين أن الاحتفال بشمّ النسيم مرتبط بالتقويم القبطي، بما أنّه يقع في اليوم التالي للفصح، إلّا أنّه في الزمن الحديث، صار المسلمون والمسيحيون واليهود المصريين، تاريخيًّا، يشتركون بالاحتفال به على حد سواء. والمشاهد الروائيّة المشمولة بالمونتاج تُبرِز هذا الجانب من التداخل الاجتماعي في الاحتفال. في المشهد الذي يسبق المونتاج، تقوم أسرتان – واحدة مسلمة والأخرى يهوديّة – بالتحضير معًا لعيد اليوم التالي. وفيما الوالدتان وابنتاهما الراشدتان يوضبّن الأطباق المصريّة التقليديّة التي أعددّنها للنزهة، يقوم خطيبا الابنتين بتسليم مساهمتهما: الفسيخ، وهو سمك مملّح يؤكل في هذه المناسبة. في المشهد الذي يلي المونتاج، تجلس الأسرتان وتأكلان على الشاطئ-يتقاسمان خبزهما بالمعنى الحرفي. معًا، يُظهر المونتاج والمشاهد الروائيّة شم النسيم على أنّه طقس عام للمصريين كلهم بغضّ النظر عن مستواهم الاجتماعي أو دينهم.
وفيلم “العزّ بهدلة” كتبه وأخرجه وأنتجه توغو مزراحي، وهو يهودي ولد في الإسكندريّة، ومن بطولة ممثل يهودي كان يؤدّي باسم فنيّ هو شالوم. ولشم النسيم جاذبيّة كبيرة لدى مزراحي، وتظهر مشاهد من الاحتفال بشكل بارز في ثلاثة من أفلامه، من بينها “العزّ بهدلة”. والمناسبة هي مصريّة بامتياز، كما أن الجميع يحيها في مصر. والاحتفال الجامع بالمناسبة يكرّس الرؤيّة التعدّديّة في الدولة المصريّة التي يعكسها مزراحي في أفلامه.
وهناك مشهد آخر في “العزّ بهدلة” يستكشف أيضًا التقاطع بين العيش المشترك وبين الطبقيّة. يبدأ البطلان، شالوم اليهودي وعبده المسلم، حياتهما في الفقر ثمّ يتسلّقان سريعًا السلّم الاجتماعي معًا، فقط ليعودا إلى ظروفهما المتواضعة بعد إحدى السقطات. في بداية الفيلم، يعمل عبده كمساعد لحّام، فيما شالوم هو بائع بطاقات يانصيب متجوّل. حين يموت اللحام، يرث عبده بشكل غير متوقّع المحل. وبفضل هذا الربح المفاجئ، يستأجر عبده المحل الفارغ المجاور لدكّانه من أجل صديقه. ويثبّت شالوم لافتة بلغتين (العربيّة والفرنسيّة) على واجهة محلّه الجديد. تقول اللافتة بالعربية “شالوم لبيع وتسديد بطاقات اللوتو”. وخلال مسار الفيلم، يبدي شالوم الناطق بالعربيّة، معرفة، وإن كانت عابرة، باللغتين الإيطاليّة واليونانيّة، إلّا إنّه لا يعرف الفرنسية. لذلك، وحين كتب لافتته، لجأ شالوم إلى نموذج متوفّر: الرموز المعتادة لتحويل العملة في المدينة الساحليّة. وعلى عكس المصطلحات الفرنسيّة التي تظهر إلى جانب العربيّة في عرض أسماء المساهمين في الفيلم وفي ترجمة العناوين الفرعية، فإن فكّ رموز اللغة الفرنسية الركيكة في خربشة شالوم المكتوبة بخطّ يده عمليّة صعبة، لأنها تقول “Chalom Agen d’echange” أو “Chalom, Agen de Change” أي شالوم للصيرفة ولكن بلغة فرنسيّة مليئة بالأخطاء.
ومثل العديد من أعمال مزراحي الشعبيّة الأخرى، الكوميديّة والموسيقيّة في الثلاثينات والأربعينات، يقدّم “العزّ بهدلة” حبكة ملتفّة من التهريج، وتأدية الأدوار، والهوية المغلوطة. في الفيلم، يبدّل شالوم هويّته كما بطاقات اللوتو. ومثل “صيرفي” يتصرّف شالوم بطرق تؤدّي إلى تغييرات تختبرها شخصيات أخرى في الفيلم. وبما أنّه خُطّط بهذه الطريقة، فإن روايات العيش المشترك في الفيلم تهدف إلى كشف “الوحدة المتنكرّة” في البلاد. ومفهوم التبديل، من التبديل الثقافي إلى تبديل الهويات، هو عنصر رئيسي في أفلام مزراحي. “توغو مزراحي وصناعة السينما المصرية” يعيد نبش العلاقة بين مفهوم التبديل والوطنيّة التعدّدية في أعمال مزراحي.
وواجهة المحل هي أيضًا موقع لتأكيد الهويّة. في مشهد سابق في “العزّ بهدلة”، تمرّ الكاميرا أمام واجهة المحل الفارغ المجاور لدكان اللحّام حيث يعمل عبده. وقد ألصقت على البوابّة المقفلة للمحل الفارغ ملصقات تروّج لفيلم مزراحي المنتج سنة 1933 “أولاد مصر”. وفي إطار سرديّة التعايش، فإن وظيفة إظهار الإعلان هي تأكيد متعمّد على الهويّة. وتقول الملصقات “توغو مزراحي يقدّم أولاد مصر” ولكن كلمة “يقدّم” مكتوبة بأحرف صغيرة جدًّا بالعربية وبالفرنسية لدرجة أنّه بالكاد تمكن رؤيتها. هكذا، فإنه وفي الوقت القصير الذي يظهر فيه الملصق، ما يلفت العين هو “توغو مزراحي” و “أولاد مصر”. مزراحي، المخرج اليهودي، يرغب بالتعريف عن نفسه، إلى جانب الشخصيّة اليهوديّة شالوم- الذي ستثبت لافتته لاحقًا على المحل ذاته -كأولاد مصر. هذا الكتاب يدرس مكانة مزراحي “ابن مصر” في تاريخ السينما المصريّة.
كان توغو مزراحي واحدًا من أكثر السينمائيين غزارة في الإنتاج في عصره. على امتداد مسيرته المهنية المثمرة التي دامت ستة عشر عامًا في صناعة الأفلام المصريّة – من 1930 حتى 1946 – قام بإخراج وإنتاج ثلاثين فيلمًا باللغة العربية، وقد كتب معظمها. بالإضافة إلى مساهماته في السينما المصريّة بالعربيّة، قام في الاستديو المصري العائد له بإنتاج أربعة أفلام باللغة اليونانيّة بين 1937 و1943.
كان تطوّر صناعة سينما محليّة مصدر فخر وطنيّ للسينمائيين المصريين، وللنقّاد وللمشاهدين معًا في وسط مرحلة كفاح ضد الاستعمار. مزراحي اعتبر نفسه ملتزمًا بهذا الجهد الجماعي. وقدّ رحبّ معاصروه بمساهماته في بناء قطاع سينما وطني.
إلّا أنّ مزراحي، ومثل العديد من اليهود الآخرين الذين كانوا يعيشون في مصر، لم يحمل أبدًا الجنسيّة المصريّة. وكيف حصل أنّ مزراحي لم يحمل يومًا الجنسيّة المصرية على رغم أن جذور أسرته في مصر تعود إلى أجيال عدّة؟ وكيف توصّل فرد لا يحمل الجنسيّة المصريّة إلى التماهي مع الصراع الوطني المصري؟
[نُشرت على «جدلية» بالإنجليزية. ترجمة هنادي سلمان]


